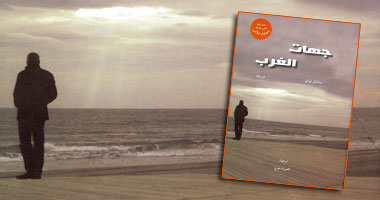لم يكن للكاتب الألماني باتريك زوسكند أن يأخذ طريقه إلى الشهرة وذيوع الصيت من غير روايته «العطر» التي عدها الكثير من النقاد والمتابعين إحدى أجمل الروايات العالمية المعاصرة، سواء من حيث موضوعها الفريد أو حبكتها المحكمة أو ربطها الحاذق بين الإبداع والانحراف، وبين الشهوة والموت. وقيمة الرواية تلك لا تكمن في إعادة الاعتبار إلى حاسة الشم التي عانت طويلا من «التمييز» والدونية ونُظر إليها كحاسة هامشية أو نافلة بالقياس إلى السمع والبصر والذوق واللمس. وإذا كان البعض قد ذهب إلى القول بأن الروائي، مهما كان عظيماً، لا يكتب سوى رواية واحدة ثم يكتفي بتكرارها أو محاكاتها في أعمال أخرى فإن «العطر» شكلت التحدي الأكثر خطورة لصاحبها بالذات ووضعت له سقفاً عالياً يصعب محاذاته أو القفز فوقه.
أقول هذا الكلام وأنا أفرغ من قراءة رواية زوسكند «الكونتراباص»، التي نقلها إلى العربية كاميران حوج والتي هي أقرب إلى مونولوج سردي قصير منها إلى الصيغة المتداولة للرواية المعروفة. ومع ذلك فإن بصمات الكاتب الالماني المميزة لا تختفي أبداً عن أنظار القارئ المتعطش إلى مطاردة الكاتب الذي احتفى بحاسة الشم كما لم يحتف أحد من قبل والذي أهدى الإنسانية المعاصرة تحفة روائية عصية على النسيان. والملاحظ في العمل الجديد كما في أعمال سابقة، من بينها رواية «الحمامة» على سبيل المثال، أن زوسكند يحاول أن يكون كاتب المهمشين والمطعونين في وجودهم في هذا العصر البالغ القساوة وغير الرؤوف بالضعفاء. ثمة أتر كافكاوي في كتابة زوسكند الذي يلتقي مع سلفه الألماني في النفاذ إلى أحشاء النفس البشرية وظلامها المعتم وفي كشف النقاب عن قدرة الآلة الرأسمالية الوحشية على سحق الإنسان ووأد طموحاته الشخصية بالكامل. وإذا كان شعور بطل كافكا بالمهانة يحوله إلى حشرة حقيقية على المستويين الاجتماعي والنفسي فإن بطل زوسكند في «الحمامة» لا يختلف كثيراً عن سابقه بحيث يتحول العثور على مرحاض إلى أحد أكثر الطموحات جدارة بالمتعة والرضى عن النفس.
في «الكونتراباص» يدفعنا زوسكند مرة جديدة إلى الاعتقاد بأن البطولة عنده هي للمعنى كما للموضوع المفاجئ والمنبثق عن قوة تحديق الكاتب في ملامح عصره وسماته الغالبة. ليس ثمة في الرواية هذه سوى بطل واحد في الخامسة والثلاثين من عمره ويشتغل ضمن الأوركسترا السيمفونية للدولة الألمانية كعازف على آلة الكونتراباص. على ان أحداً غير زوسكند لا يملك في اعتقادي القدرة على استنباط عمل روائي كامل من تلك العلاقة الملتبسة والمعقدة بين العازف الشاب وآلته الموسيقية التي لا يكاد أحد يصفق لها أو يعيرها انتباهاً رغم كونها الأضخم بين الآلات. ورغم ان الأوركسترا السيمفونية تتحول في الكثير من وجوهها إلى مجسم مصغر لهرمية الدولة الصارمة والمجتمع البالغ الانضباط، فإن الكونتراباص بشكله الأنثوي الفاقع يتراجع موقعه إلى الصفوف الخلفية لتتقدمه دائما الكمنجات وسائر الآلات الوترية وآلات النفخ والقرع بالأيدي. ورغم ضخامته البادية فهو لا يعتبر قطعة مميزة من أثاث المنزل، كما هو حال البيانو، ولا يلقى من الجمهور المحتشد سوى التبرم وإشاحة السمع، مهما بلغت مهارة عازفه.
سيكتشف القارئ من سياق النص ان والد العازف كان متسلطاً وقاسي القلب وأن والدته التي كان شديد التعلق بها لم تكن تعيره الانتباه الكافي بما جعل اختيار الابن العزف على الكونتراباص دون سواه من الآلات نوعاً من الانتقام من الأم الضعيفة والهشة ومن الأب المستبد الذي لا يكف عن اغتصاب الأم وإذلالها يوميا. ولكنه انتقام من النفس وتعذيبها اليومي في الوقت ذاته عبر آلة بالغة الغباء يتفنن زوسكند في استعراض تاريخها الهامشي وإعراض الموسيقيين الكبار كبتهوفن وموزار وباخ وفاغنر عن العزف عليها مطلقاً.
تنبغي الإشارة هنا الى أن زوسكند يختار لروايته أسلوب المونولوج الداخلي الذي يوفر له ذريعة السرد من خلال بطله العازف الذي يروي، شبه مخمور، علاقته المأساوية بالآلة الوحيدة التي تشبهه في غرابتها وهامشيتها الدونية. وإذ يضع المؤلف لعمله عناوين فرعية متتالية تتعلق بحالة بطله النفسية والجسدية وبهمسه وصراخه واحتسائه الكحول، يبدو العمل أقرب إلى مسرحية بفصل واحد يمكن مخرجاً حاذقاً أن يمنحها كل أسباب النجاح على خشبة المسرح. أما قصة الحب المتخيلة التي راح ينسجها البطل مع مغنية الأوبرا سارة فلم تكن سوى الرد الرمزي على تجاهل الأم وإهمالها له، أو محاولة مضنية لاستعادة صورة الأم في فتاة تماثلها في الضعف والبراءة الرومنسية. والمؤلم في الأمر أن استبسال البطل في العزف على آلته لدى انضمام مغنية الأوبرا الشابة إلى حفل الأوركسترا السيمفونية لم يتح لسارة أن تراه بأم العين وهو المنزوي كعادته في الصف الأخير من العازفين. ولما كان لا بد للعازف المهمش أن يجد لحياته معنى ما أو حدثاً دراماتيكياً يخرجها من الرتابة فهو يجد نفسه أمام خيار انتحاري يقضي بالخروج من مكانه في ذروة الاحتفال وإعلان حبه لسارة بصوت جهوري حتى لو أدى الأمر إلى طرده من وظيفته.
هكذا يبدو باتريك زوسكند مهموماً بالحواس أكثر من أي شيء آخر، بحيث تبدو حاسة السمع في «الكونتراباص» هي الرديف الطبيعي لحاسة الشم في «العطر» مع فارق ملحوظ في المعالجة وقوة السرد. وإذا كان الكاتب الألماني معنياً دائماً بإثارة الأسئلة الشائكة والملغزة فإن سؤالا إضافياً في الرواية الأخيرة لا بد أن يطرح نفسه على القارئ ومفاده أن الإنسان إذ يختار مهنته أو آلة عمله فهل يفعل ذلك لأنها «تشبهه» في الأصل أم أن الشبه يحصل في ما بعد بسبب المجاورة والتعايش. وهل شعور بطل زوسكند بالتهميش دفعه إلى اختيار آلة هامشية للعزف أم أن الشعور تأتى لاحقاً بفعل الآلة نفسها؟ واستطراداً أقول، في ما يتعدى دائرة العزف ويلامس علاقة الفرد مع المركبات الآلية التي يختار قيادتها: هل تصبح لسائق الجرافة أو القاطرة أو الشاحنة الطباع الفظة لهذه الآليات من خلال المعايشة أم أنه يختار قيادتها لفظاظة تكوينية في طباعه؟ مع التقدير الكامل بالطبع لجميع المهن، ومع الابتعاد عن التعميم القاطع والشمولي. ولم لم تكن ثمة علاقة جدلية بين الاثنين فلماذا تختار النساء أقل أنواع السيارات ضخامة وفظاظة وأكثرها نمنمة ورهافة وصلة بالأنوثة؟!
أقول هذا الكلام وأنا أفرغ من قراءة رواية زوسكند «الكونتراباص»، التي نقلها إلى العربية كاميران حوج والتي هي أقرب إلى مونولوج سردي قصير منها إلى الصيغة المتداولة للرواية المعروفة. ومع ذلك فإن بصمات الكاتب الالماني المميزة لا تختفي أبداً عن أنظار القارئ المتعطش إلى مطاردة الكاتب الذي احتفى بحاسة الشم كما لم يحتف أحد من قبل والذي أهدى الإنسانية المعاصرة تحفة روائية عصية على النسيان. والملاحظ في العمل الجديد كما في أعمال سابقة، من بينها رواية «الحمامة» على سبيل المثال، أن زوسكند يحاول أن يكون كاتب المهمشين والمطعونين في وجودهم في هذا العصر البالغ القساوة وغير الرؤوف بالضعفاء. ثمة أتر كافكاوي في كتابة زوسكند الذي يلتقي مع سلفه الألماني في النفاذ إلى أحشاء النفس البشرية وظلامها المعتم وفي كشف النقاب عن قدرة الآلة الرأسمالية الوحشية على سحق الإنسان ووأد طموحاته الشخصية بالكامل. وإذا كان شعور بطل كافكا بالمهانة يحوله إلى حشرة حقيقية على المستويين الاجتماعي والنفسي فإن بطل زوسكند في «الحمامة» لا يختلف كثيراً عن سابقه بحيث يتحول العثور على مرحاض إلى أحد أكثر الطموحات جدارة بالمتعة والرضى عن النفس.
في «الكونتراباص» يدفعنا زوسكند مرة جديدة إلى الاعتقاد بأن البطولة عنده هي للمعنى كما للموضوع المفاجئ والمنبثق عن قوة تحديق الكاتب في ملامح عصره وسماته الغالبة. ليس ثمة في الرواية هذه سوى بطل واحد في الخامسة والثلاثين من عمره ويشتغل ضمن الأوركسترا السيمفونية للدولة الألمانية كعازف على آلة الكونتراباص. على ان أحداً غير زوسكند لا يملك في اعتقادي القدرة على استنباط عمل روائي كامل من تلك العلاقة الملتبسة والمعقدة بين العازف الشاب وآلته الموسيقية التي لا يكاد أحد يصفق لها أو يعيرها انتباهاً رغم كونها الأضخم بين الآلات. ورغم ان الأوركسترا السيمفونية تتحول في الكثير من وجوهها إلى مجسم مصغر لهرمية الدولة الصارمة والمجتمع البالغ الانضباط، فإن الكونتراباص بشكله الأنثوي الفاقع يتراجع موقعه إلى الصفوف الخلفية لتتقدمه دائما الكمنجات وسائر الآلات الوترية وآلات النفخ والقرع بالأيدي. ورغم ضخامته البادية فهو لا يعتبر قطعة مميزة من أثاث المنزل، كما هو حال البيانو، ولا يلقى من الجمهور المحتشد سوى التبرم وإشاحة السمع، مهما بلغت مهارة عازفه.
سيكتشف القارئ من سياق النص ان والد العازف كان متسلطاً وقاسي القلب وأن والدته التي كان شديد التعلق بها لم تكن تعيره الانتباه الكافي بما جعل اختيار الابن العزف على الكونتراباص دون سواه من الآلات نوعاً من الانتقام من الأم الضعيفة والهشة ومن الأب المستبد الذي لا يكف عن اغتصاب الأم وإذلالها يوميا. ولكنه انتقام من النفس وتعذيبها اليومي في الوقت ذاته عبر آلة بالغة الغباء يتفنن زوسكند في استعراض تاريخها الهامشي وإعراض الموسيقيين الكبار كبتهوفن وموزار وباخ وفاغنر عن العزف عليها مطلقاً.
تنبغي الإشارة هنا الى أن زوسكند يختار لروايته أسلوب المونولوج الداخلي الذي يوفر له ذريعة السرد من خلال بطله العازف الذي يروي، شبه مخمور، علاقته المأساوية بالآلة الوحيدة التي تشبهه في غرابتها وهامشيتها الدونية. وإذ يضع المؤلف لعمله عناوين فرعية متتالية تتعلق بحالة بطله النفسية والجسدية وبهمسه وصراخه واحتسائه الكحول، يبدو العمل أقرب إلى مسرحية بفصل واحد يمكن مخرجاً حاذقاً أن يمنحها كل أسباب النجاح على خشبة المسرح. أما قصة الحب المتخيلة التي راح ينسجها البطل مع مغنية الأوبرا سارة فلم تكن سوى الرد الرمزي على تجاهل الأم وإهمالها له، أو محاولة مضنية لاستعادة صورة الأم في فتاة تماثلها في الضعف والبراءة الرومنسية. والمؤلم في الأمر أن استبسال البطل في العزف على آلته لدى انضمام مغنية الأوبرا الشابة إلى حفل الأوركسترا السيمفونية لم يتح لسارة أن تراه بأم العين وهو المنزوي كعادته في الصف الأخير من العازفين. ولما كان لا بد للعازف المهمش أن يجد لحياته معنى ما أو حدثاً دراماتيكياً يخرجها من الرتابة فهو يجد نفسه أمام خيار انتحاري يقضي بالخروج من مكانه في ذروة الاحتفال وإعلان حبه لسارة بصوت جهوري حتى لو أدى الأمر إلى طرده من وظيفته.
هكذا يبدو باتريك زوسكند مهموماً بالحواس أكثر من أي شيء آخر، بحيث تبدو حاسة السمع في «الكونتراباص» هي الرديف الطبيعي لحاسة الشم في «العطر» مع فارق ملحوظ في المعالجة وقوة السرد. وإذا كان الكاتب الألماني معنياً دائماً بإثارة الأسئلة الشائكة والملغزة فإن سؤالا إضافياً في الرواية الأخيرة لا بد أن يطرح نفسه على القارئ ومفاده أن الإنسان إذ يختار مهنته أو آلة عمله فهل يفعل ذلك لأنها «تشبهه» في الأصل أم أن الشبه يحصل في ما بعد بسبب المجاورة والتعايش. وهل شعور بطل زوسكند بالتهميش دفعه إلى اختيار آلة هامشية للعزف أم أن الشعور تأتى لاحقاً بفعل الآلة نفسها؟ واستطراداً أقول، في ما يتعدى دائرة العزف ويلامس علاقة الفرد مع المركبات الآلية التي يختار قيادتها: هل تصبح لسائق الجرافة أو القاطرة أو الشاحنة الطباع الفظة لهذه الآليات من خلال المعايشة أم أنه يختار قيادتها لفظاظة تكوينية في طباعه؟ مع التقدير الكامل بالطبع لجميع المهن، ومع الابتعاد عن التعميم القاطع والشمولي. ولم لم تكن ثمة علاقة جدلية بين الاثنين فلماذا تختار النساء أقل أنواع السيارات ضخامة وفظاظة وأكثرها نمنمة ورهافة وصلة بالأنوثة؟!